القاهرة 18 ابريل 2017 الساعة 02:26 م
روّعت التفجيرات في كنيستي طنطا والإسكندرية، في تزامن واحد تقريباً، كل من يدرك أبعاد المخطط الخبيث لضرب مصر في مقتل، فالحرب ضد الإرهاب مستعرة في سيناء منذ سنوات عدة وأبلى فيها الجيش المصري بلاءً شديداً حتى اقتحم «جبل الحلال» بكل مصاعبه ومتاعبه. ولأن مصر دولة عصية على التقسيم فقد توهم المخططون لترويع الشعب المصري  أن ضرب وحدته الوطنية هو أقصر الطرق للنيل من مصر بملايينها الذين يقتربون من المئة، وتصور الإرهابيون أن المدخل الأسرع هو إيجاد هوة بين المسلمين والأقباط في مصر على اعتبار أنها تضم أكبر تجمع مسيحي في غرب آسيا والشرق الأوسط كله، وهم لا يدركون أن الكنيسة المصرية وطنية بطبيعتها، صامدة بتاريخها، فالأقباط هم الذين ينتسب إليهم «عصر الشهداء» في الحقبة الرومانية، ولكي لا تضيع معالم الأفكار المحددة في غمار الألفاظ الواسعة فإننا نتطرق لتحليل العلاقة بين التطرف الإسلامي والتجمع المسيحي في مصر، خصوصاً الأقباط، من خلال النقاط التالية:
أن ضرب وحدته الوطنية هو أقصر الطرق للنيل من مصر بملايينها الذين يقتربون من المئة، وتصور الإرهابيون أن المدخل الأسرع هو إيجاد هوة بين المسلمين والأقباط في مصر على اعتبار أنها تضم أكبر تجمع مسيحي في غرب آسيا والشرق الأوسط كله، وهم لا يدركون أن الكنيسة المصرية وطنية بطبيعتها، صامدة بتاريخها، فالأقباط هم الذين ينتسب إليهم «عصر الشهداء» في الحقبة الرومانية، ولكي لا تضيع معالم الأفكار المحددة في غمار الألفاظ الواسعة فإننا نتطرق لتحليل العلاقة بين التطرف الإسلامي والتجمع المسيحي في مصر، خصوصاً الأقباط، من خلال النقاط التالية:
أولاً: الأقباط أقلية بالمعنى العددي فقط ولكنهم كغيرهم من المصريين حيث تصعب التفرقة في الملامح بين مواطن وآخر، وهم بالتأكيد، شأن الأغلبية المسلمة في مصر، امتداد طبيعي لشعب استقر في هذه البقعة من الأرض عبر آلاف السنين وظهرت قيمته مع الحضارة الفرعونية الملهمة وامتدادها في ظل حكم الإغريق والرومان ثم العرب بعد الفتح الإسلامي، وقد يتصور البعض أنه بدخول الفاتح العربي تحولت مصر إلى دولة عربية إسلامية، وهذه مغالطة علمية، لأن اللغة القبطية ظلت سائدة مع أغلبية مسيحية في مصر حتى بداية العصر الفاطمي وقدوم حكام جدد من الشمال الأفريقي ينتسبون إلى فاطمة الزهراء، فلما اضطربت أحوال المصريين وزادت ضغوط الحكام عليهم بالضرائب أحياناً وبالجزية دائماً، فإن الأغلب الأعم من الأقباط دخلوا في الإسلام كنوع من الخلاص أمام سطوة المزاج المتقلب لـ «الحاكم بأمر الله» الفاطمي، وعندما قرعت الكنائس القبطية أجراسها تدعو لإقامة الصلوات باللغة العربية فقد كان ذلك هو الإيذان الفعلي لتمام عروبة مصر واكتمال أغلبيتها المسلمة، ولا نزعم أن الحياة كانت سخاءً رخاءً فقد تعرض الأقباط لموجات من الاضطهاد منذ العصر الروماني وبلغ الاضطهاد بهم حد الفرار في الصحراء وإقامة بقاع للرهبنة حتى سميت تلك الفترة بحق عصر الشهداء، كما أسلفنا، وظلت أحوال الأقباط متقلبة في مصر على رغم أن مساهمتهم في الوظائف العليا كانت ملحوظة، وقد استوزرهم بعض الولاة وظهرت منهم أسماء مثل المعلم غالي في عهد محمد علي، كما أن أول رئيس وزراء (نوبار باشا) كان مسيحياً أرمنياً وتولى بطرس باشا غالي رئاسة الوزارة إلى أن صرعته رصاصات إبراهيم ناصف الورداني عام 1910، وبالمناسبة فإن بطرس غالي الكبير هو الذي أنشأ جمعية التوفيق القبطية عام 1875، وجرى اتهامه بعد ذلك بالضلوع في محاكمة «دنشواي» وغيرها من القضايا التي يشير بعض الكتابات إليها للتشكيك في وطنيته وهو بالمناسبة
الجد الأكبر للدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وتميزت بين الأقباط شخصيات مرموقة في مجالات الحياة المختلفة، نذكر منهم جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب وعازف البيانو الشهير رمزي يسي، فضلاً عن أسماء كثيرة في مجالات الفن والأدب والصحافة والثقافة والتعليم بصفة خاصة لذلك فإن مساهمتهم في الدولة المصرية الحديثة أمر يصعب إنكاره.
ثانياً: عندما ولدت جماعة «الإخوان المسلمين» على يد الشيخ حسن البنا عام 1928 حاولت الجماعة والشيخ احتواء الأقباط ولكن القلق المسيحي العام بدأ يتزايد نتيجة اقتحام تيار الإسلام السياسي مراكز السلطة، وحدثت مواجهات دامية تمثلت في حركة الاغتيالات التي دبرت لها الجماعة في أربعينات القرن الماضي ثم جاءت ثورة 23 تموز (يوليو) لتضع المواجهة في أشد مراحلها بين «الإخوان» والدولة حتى حسمها الرئيس جمال عبد الناصر بضربتين كبيرتين وجههما للجماعة عام 1954 و1965، حيث انتهت الأولى بإعدام سبعة من أكبر قيادات «الإخوان» وانتهت الثانية بإعدام القطب «الإخواني» الشهير سيد قطب ورفيق له، وعندما وقعت نكسة عام 1967 سرت موجة شعبية داعمة لتيار الإسلام السياسي بما فيه «الإخوان»، بحجة أن النكسة جاءت عقاباً إلهياً بسبب ابتعاد عبد الناصر -الحاكم شبه العلماني- الذي أيد اليونان ضد تركيا المسلمة، وأيد الهند ضد باكستان المسلمة، وفتح خلافاً واسعاً مع المملكة العربية السعودية، ورفض فكرة الحلف الإسلامي، وأعاد تنظيم الأزهر فضلاً عن مصادرة الوقف الخيري وإلغاء المحاكم الشرعية، وعندما جاء الرئيس أنور السادات إلى السلطة أراد أن يضرب فلول اليسار المصري والناصريين بدعمه جماعة «الإخوان المسلمين» والدفع بهم إلى ساحة المشهد السياسي، وقد تنامى دور الجماعة وزادت معه مخاوف الأقباط حتى كانت عاصفة الخلاف بين السادات وبابا
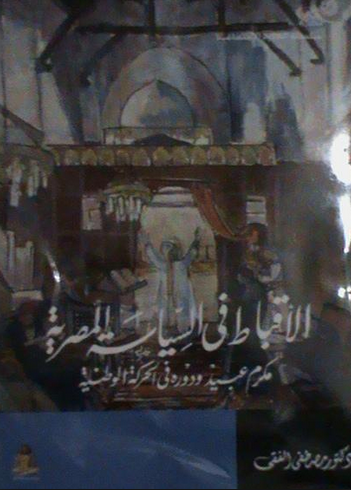
الأقباط الجديد أيضاً شنودة الثالث والتي انتهت بإبعاد الأخير وسحب اعتراف الدولة بأختامه، وعندما جاء الرئيس حسني مبارك حظي الأقباط ببعض الارتياح بعد الأحداث الدامية في «الخانكة» و «الزاوية الحمراء» فضلاً عن مذبحة «الكشح» الدامية في صعيد مصر، وحرص مبارك على علاقة طيبة مع الكنيسة وإن تخللتها أزمات عدة، حيث كنت أنا شخصياً فيها مسؤولَ الاتصال بين الرئيس والبابا بحكم موقعي في الرئاسة ودراستي الطويلة عن الأقباط في السياسة المصرية التي حصلت بها على الدكتوراه من جامعة لندن عام 1977.
ثالثاً: إن علاقة نظام الرئيس الأسبق مبارك بالأقباط كانت علاقة هادئة في مجملها على رغم وقوع أحداث طائفية متعددة، فقد كان البابا شنودة الثالث متشدداً بطبيعته وكان يترك إقامته بالكاتدرائية في القاهرة متجهاً إلى الدير في «وادي النطرون»، ولقد قمت شخصياً بإقناعه بالعودة إلى مقره بعد أحداث «العمرانية» في نهايات عام 2009، ثم وقعت جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية في مطلع عام 2010، وهذا الحادث يدل على أن مصر مستهدفة في أقباطها من قبل ثورة 25 كانون الثاني (يناير) ثم حدوث المواجهة بين النظام وجماعة «الإخوان» في نهاية حزيران (يونيو) 2013، وفي ظننا أن الأقباط لا يستحقون ما يحدث لهم، فقد كانت مواقفهم الوطنية والقومية متمشية مع اتجاه الأغلب الأعم من المصريين، ولا نكاد نعرف لهم إلا حادثاً سلبياً وحيداً عندما قام المدعو «المعلم يعقوب» (جنرال يعقوب) بدعم حملة نابليون ضد التيار الوطني العام حينذاك، ولا بد أن نعترف هنا أن المجتمع القبطي لفظه وقتها وحرمه البابا من بركات الكنيسة واعتبره مارقاً إلى أن مات في عرض البحر عائداً من مرسيليا مع فلول الحملة الفرنسية، وكانت أدوار الأقباط في كل الحروب أدواراً مشرفة في مجملها، مؤكدة أن عروبتهم ومصريتهم لا تحتاجان إلى برهان. إن أقباط مصر ليسوا جالية أجنبية ولكنهم مواطنون أصليون عاشوا على أرض بلدهم الطيب منذ فجر التاريخ، فليعِ الجميع أن الدين لله وأن الوطن للجميع!
رابعاً: تولد انطباع تاريخي خاطئ بأن الأقباط لا يتحمسون لعروبة مصر على اعتبار أنهم مكون مختلف لم يأتِ من الجزيرة العربية أو غيرها ولكنهم مرتبطون بالأرض المصرية منذ عشرات القرون، وعزز هذا الإحساس ذلك الارتباط التلقائي بين الإسلام والعروبة، وتكرس هذا المفهوم لدى عامة المصريين والعرب إلى أن قام السياسي القبطي المجاهد الكبير مكرم عبيد باشا سكرتير عام حزب الأغلبية (الوفد) والذي قام بجولة في مطلع أربعينات القرن الماضي إلى منطقة الشام –قبل ميلاد جامعة الدول العربية– فزار حيفا ويافا وعكا وبيروت ودمشق، وكان خطيباً مفوهاً فتحدث عن عروبة الأقباط الثقافية وأنهم، شأن غيرهم من أبناء المنطقة تعرّبوا وأصبحوا جزءاً لا يتجزأ من كيان الأمة، ولقيت خطب مكرم باشا صدى كبيراً في كل المدن التي زارها وجاءت تأكيداً لتمسك الأقباط بعروبتهم ورفضهم التشكيك في ذلك، فالعروبة ثقافة وليست ديناً، ويهمنا هنا أن نؤكد أن مكرم عبيد باشا أدرك بسعة أفقه أن علاقة الأقباط بجماعة «الإخوان المسلمين» ينبغي أن تكون مستقرة فكان هو السياسي الوحيد الذي شارك في تشييع جنازة الشيخ حسن البنا الذي لقي مصرعه رداً على مقتل النقراشي باشا، وبذلك نجد أن الأقباط حاولوا في كثير من المناسبات تأكيد عروبتهم واحترامهم للدين الغالب في المنطقة، خصوصاً أنهم جزء لا يتجزأ مثل غيرهم من المسيحيين بل واليهود الذين ساهموا مساهمات مشهودة في الحضارة العربية الإسلامية في مجملها.
خامساً: مثلما أبلى الأقباط بلاء حسناً في ثورة 1919 وأثبتوا مصريتهم الكاملة ووطنيتهم الرائعة، فعلوا الأمر ذاته في الفترة الأولى من ثورة 25 يناير، فاحتشدوا في «ميدان التحرير» مع أشقائهم المسلمين واعتصموا فيه حتى سقط نظام الرئيس الأسبق مبارك، وهم الذين وقفوا في صلابة يوم 30 يونيو ضد محاولة «الإخوان» العبث بالهوية المصرية فكانوا بحق تعبيراً صادقاً عن مصر التاريخ والحضارة والوطن، واستقبل المصريون موقف الأقباط بالحفاوة والتقدير حتى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار الكاتدرائية في أعياد الميلاد وهو أمر غير مسبوق في تاريخ حكام مصر، فضلاً عن قيام الدولة بإصلاح جميع الكنائس التي تضررت في عمليات الفوضى والعنف التي جاءت بعد أحداث 3 يوليو 2013 والتي شارك فيها البابا تواضروس بشكل فعال ومباشر إلى جانب شيخ الأزهر»، وكذلك ما حدث تجاه بعض المؤسسات القبطية بعد فض «اعتصام رابعة»، لأن «الإخوان» توهموا –ولا يزالون– أن الأقباط كانوا عنصراً فعالاً في حركة «التمرد» التي أسقطت نظامهم، وسوف نرى أن الأقباط يتحدثون عن مصر بوطنية صادقة في مناسبات مختلفة، فمثلما كان البابا «شنودة يكرر المقولة الخالدة لـمكرم عبيد باشا من أن «مصر ليست وطناً نعيش فيه ولكنها وطن يعيش فينا»، فإن البابا تواضروس الثاني هو الذي قال أيضاً «وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن».
فهل يستحق هؤلاء تفجير كنائسهم وقتل نسائهم وأطفالهم؟ إن الإسلام أبعد ما يكون عن ذلك لأنه دين الرحمة والتسامح مثلما أن المسيحية هي دين التواضع والمحبة.